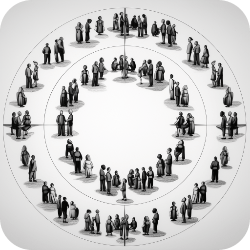قمت خلال الأسابيع الماضية بحذف جميع تطبيقات الشبكات الاجتماعية من هاتفي وألغيت اشتراكي في تويتر بلو. أظن أن لغاء الاشتراك جاء ردًا على الاكتئاب الذي يصيبني بعد كل تصفح للتطبيق، وأضف إلى ذلك أن استماعي إلى هذه الحلقة من بودكاست Search Engine جعلتني أقرر – في الوقت الحالي – إيقاف اشتراكي في تويتر بلو. أظن… متابعة قراءة نهاية الشبكات الاجتماعية المفتوحة
الوسم: شبكات اجتماعية
تسطيح الحوارات
تميل الكثير من الجدالات في الشبكات الاجتماعية هذه الأيام في محاولة الوصول إلى الإجابة عبر تسطيح الطرح قدر الإمكان. ولنأخذ مثال “الألعاب العنيفة” التي تتسبب في انحراف المراهقين وارتكاب الجرائم. مشكلة هذا التفكير هو تبسيط مشاكل معقدة وحصرها في سبب واحد. في حين أن الإنسان هو حصيلة العديد من العوامل التي تشكل شخصيته، من بيئة، تربية،… متابعة قراءة تسطيح الحوارات
الشبكات الاجتماعية لا تصلح للنقاش
لا زلت أذكر بدايات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك. كان الكل سعيداً يشارك مقتطفات بسيطة وسعيدة من حياته، وكل يوم كان مليئاً بالإيجابية، لكن هذه الصورة تغيرت وأصبحنا نغرق في الكثير من الصراعات بين مختلف الناس الذين يحاولون اثبات صحة وجهة نظرهم. تتعرض مقالة بعنوان “Why I Stopped Arguing Politics on Social Media” لهذه الظاهرة… متابعة قراءة الشبكات الاجتماعية لا تصلح للنقاش
ثقافة الكنسلة (أو الإقصاء)
“أُسكِتَ صوتي ، أخذه الآخرون، واستخدموه في قول شيء مختلف” تصف هذه الجملة واقعًا يحدث كل يوم في الإنترنت، وقد استعرتها من “نوة برادلي” الذي كتب تدوينة طويلة عن الإقصاء، وهي ظاهرة جديدة انتشرت وتعززت بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، وهي أن يتم الدعوة إلى مقاطعة ومحاربة شخص ما بسبب موقف، فعل، ورغم أن النوايا “قد”… متابعة قراءة ثقافة الكنسلة (أو الإقصاء)
من يتذكر الشبكة الاجتماعية التي أطلقتها أبل؟
قد ينسى (أو لا يتذكر) الكثير من الناس، أن أبل حاولت دخول مجال الشبكات الاجتماعية قبل عشر سنوات عبر خدمة پينج (Ping). لعلي كتبت عنها قبل سنوات حين كنت أغطي الأخبار التقنية على مدونة تيدوز. كانت الشبكات الاجتماعية الشهيرة في تلك الفترة تتسم بالجمال والبراءة، التي تتميز بها أي مواقع جديدة. وكان فيسبوك مكاناً جميلاً لتبادل التحديثات، ودعوة… متابعة قراءة من يتذكر الشبكة الاجتماعية التي أطلقتها أبل؟